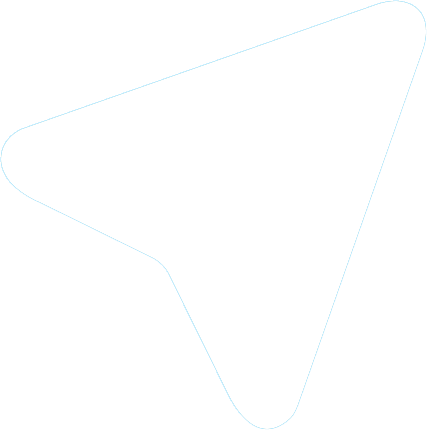هل الدول الديمقراطية اليوم هي ديمقراطية فعلا؟، هل الشعب يختار من يمثله بكامل حريته؟، هل الرأي العام يعبر فعلا عن اراء الشعب؟، هل حرية التعبير عن الرأي هي مضمونة ومصونة؟، اسئلة اثارتني للحديث عن مفهوم طالما دارت حوله الغموض بين مفهومه وشروط تطبيقه وتقبل المجتمعات له.
فالديمقراطية هي لعبة سياسية، ابطال هذه اللعبة هم من يحكمون الشعوب، والجمهور لهذه اللعبة هم الشعب نفسه الذين يصوتون وينتخبون هؤلاء الابطال، واللاعبون هم كل من يعملون بالسياسة، لكن هنالك من هو اهم من الابطال ومن الجمهور ومن اللاعبين وحتى اهم من طريقة اللعب!، الاهم هو من يضع قواعد هذه اللعبة؟.
قواعد اللعبة هنا اهم واخطر بكثير من قوة اللاعبين او من جودة اللعب، اي لو اراد لاعب معين ان يعمل بالسياسة فيجب عليه ان يتقيد بقواعد اللعبة وهذه القواعد تقول اذا اراد شخص معين ان يصبح بطلا سياسيا يجب ان يعرض نفسه وبرنامجه الانتخابي على الناس حتى يصوتوا له، ويحتاج من اجل ذلك الى حملة انتخابية وهذه الحملات عادة ما تكون مكلفة جدا ماديا، فإما ان يكون البطل من اصحاب رؤوس الاموال ويتكفل حملته بنفسه وامواله او ان يستعين بالاحزاب والتكتلات السياسية الكبيرة وهؤلاء لن يمولوا له حملته (بالمجان) وانما سيمولون الحملة الانتخابية من اجل ان ينجح وينفذ لهم اجنداتهم الحزبية والسياسية والاقتصادية، يعني يصبح البطل المنتخب من قبل الشعب الذي من المفترض ان يدافع عن حقوق وقضايا الشعب سيصبح منفذ لاجندات هذه الاحزاب او تلك التكتلات السياسية، واذا ما خالفهم فأنه قد يحكم على مشواره السياسي بأنه قد انتهى تماما.
من المفارقات الكبيرة في اللعبة السياسية ان الاعلام ليس بيد الشعب ولا يملك سلطة عليه، وانما عادة ما يكون الاعلام في يد الاحزاب والتكتلات الصغيرة والكبيرة على حد سواء مع ان الاعلام هو المكون الرئيسي للرأي العام، يعني في النهاية الجهة الاهم التي تستطيع ان تشكل الرأي العام هي من بيدها الاعلام او من بيدها المال.
لماذا الاعلام خطير الى هذه الدرجة؟، ولماذا له هذا الدور الكبير في تشكيل الرأي العام؟، سبب ذلك يعود الى تحيز معرفي شهير وخطير جدا اسمه (تحيز الوفرة)، هذا التحيز يقول ان الكلام الذي تسمعه مرارا وتكرارا سوف تتأثر به وربما تصدقه، وهناك عبارة اوضحت معنى هذا التحيز اطلقها وزير الدعاية السياسية في زمن هتلر (جوزيف جوبلز) حين قال: اكذب.. ثم اكذب.. ثم اكذب حتى يصدقك الناس.
فاذا كان الاعلام بيد جهة معينة وليس هناك رقابة حقيقية على ما يبثه الاعلام عبر وسائله فأنها تستطيع ان تكذب كثيرا وتستطيع ان تجعل الناس تصدق ما تريد، ربما يقول البعض: لكن الوضع اليوم مختلف بسبب وجود منصات التواصل الاجتماعي واتاحتها للجميع بأن يعبروا ويكتبوا ما يدور في خاطرهم وبحريتهم الشخصية دون حساب او عقاب او مراقبة!.
نقول: وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست وسائل بريئة!، نعم هذه الوسائل لا تتكلم شيئا ولا تنشر محتوى، وانما نحن الذين ننشر المحتوى ونكتب العبارات والجمل ونعبر عن اراؤنا، لكنهم ايضا هم من يضع قواعد اللعبة وهذه القواعد هي معايير النشر في هذه المنصات، يعني هم الذين يقولون ما هي المواضيع التي لا يجوز ان نتكلم عنها وما هي المصطلحات التي لا يجوز التحدث بها.. الخ، وهذا له تأثير اكبر حتى من تحيز الوفرة.
على سبيل المثال لا الحصر، اذا ما كان شخصا يتابع قناة فضائية معينة وهذه القناة يختلف معها في الرأي ويكذب كل ما تقوله وتعرضه القناة، لكنه يجلس امامها صباحا ومساء ويتعرض ما تقوله وما تملي عليه، سيتأثر بكلامها كثيرا عاجلا ام اجلا، فلو اتيحت له فرصة العمل كمذيع مثلا في هذه القناة واصبح ملتزما بقوانينها وسياستها وسياسة التحرير الخاصة بها سيكون تأثيره بفكر هذه القناة اكبر بكثير، نعم ما سيجري عليه هو تماما عملية غسيل العقل والذي سيقوم بهذه العملية هو الشخص نفسه بمحض ارادته.
من اهم قيم الديمقراطية هو حرية التعبير عن الرأي وانها مضمونة ومصونة ومقدسة، لكن في حرب غزة الاخيرة فضحت لنا الدول التي تدعي بالديمقراطية، وكشفت ان حرية التعبير عن الرأي ما هي الا اكذوبة يمارسها اعلام تلك الدول، ويعتبر كثير من الأشخاص أن النظام الديمقراطي هو الحل الأمثل للشعوب، وهذه دعاية غربية زائفة، يستغلونها للتدخل في شؤون الدول الأخرى لنشر الحرية والديمقراطية عبر الدبابات وطائرات الدرونز، وبناء على هذا التصور خسرت كثير من الثورات والمواقف السياسية معناها وتحولت إلى خسائر وهزائم وفساد، لأنها ظنت أن الديمقراطية –بدون شروط تطبيقها- هي الحل الامثل.
ونستطع توصيف الديمقراطية في المجتمعات العربية والاسلامية كما مثلها الفيلسوف نعوم تشومسكي فهي نوعان؛ الأولى ديمقراطية مشاركة وهي التي يكون التأثير فيها للشعب إذ هو الذي يصنع القرار ويتحكم فيه، وهو الذي بإمكانه تغيير قواعد اللعبة، إذ الكلمة الأخيرة له، والثانية ديمقراطية مشاهدة وهي السائدة في المجتمعات العربية والاسلامية، حيث يتم طبخ القرارات السياسية من فوق بنتائجها المُعدة مسبقا، ولا يزيد دور الشعب هاهنا إلا تكديس صناديق الاقتراع بالأوراق التي لا تزيد ولا تنقص من الواقع شيء، فقد اعتادت الأنظمة العربية على اللعب على سيمفونية تجهيل الشعب وتحنيطه في اتجاه تربيته على الرضوخ لأمر الواقع وتقبله كما هو، كأنه القدر الذي لا يرد!!، وتزييف إرادته وقناعاته في سبيل خدمة السلطة، وحتى إن لاحت في الآفاق بعض بوادر ديمقراطية المشاركة غير أنها لم تترك على حال سبيلها، تمضي وفق سنة الإرادة الشعبية التي ناضلت من أجلها.
والديمقراطية في حال تحقيقها تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، من خلال قوانين ونظم علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وهذه العلاقة تصل بالمجتمع في نهاية المطاف إلى أن التنافس الايجابي هو من يحدد شكل النظام السياسي- الديمقراطي من خلال التداول السلمي للسلطة. اما اذا كانت ديمقراطية لا تؤمن إلا بالمصلحة الخاصة ولا تلتفت الى مصلحة الشعب والوطن، فهي ديمقراطية معاقة او إنها ديمقراطية وهمية، وأمام هذا الواقع، لا يمكننا إلا أن نحتفظ بمقولة (الانتقال الديمقراطي) هكذا بين قوسين، مادام أن واقع الحال لا يشهد لها بالصحة والتأييد. عسى أن يأتي ذلك اليوم الذي نستطيع فيه أن نرفع عنها تلك الاقواس وإلى الأبد.